معرفة
أصداف ولآلئ: في معرفة البدايات
خمسون عامًا من الأسئلة والكتب، من النداءات البعيدة والصور التي لا تُنسى، من الأصداف التي لا تحتوي شيئًا، والآلئ التي جاءت بعد عناء الغوص الطويل.
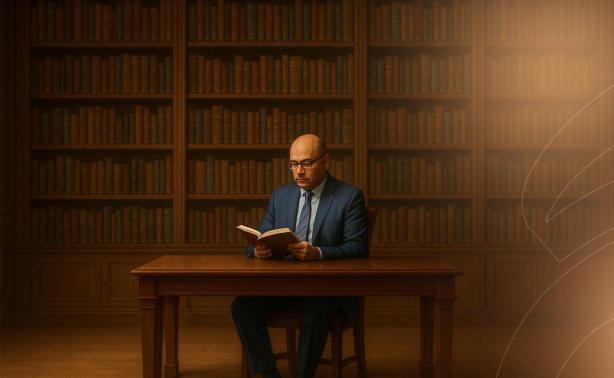 صورة تعبيرية مصنوعة بواسطة ChatGPT
صورة تعبيرية مصنوعة بواسطة ChatGPT
أستهل بهذا المقال سلسلة من الحلقات التي تشكل في مجملها ما يمكن أن نطلق عليه رحلة تأمل وجولات استعادية واسعة في بحر الذاكرة الزاخر وتلافيفها ودهاليزها العجيبة والغريبة والمريبة أيضًا!
قرابة العامين فقط وأكمل الخمسين من عمري، إن أذن المولى، وأقترب من تخوم العبارة الشهيرة المتكررة (على مشارف الخمسين).
الشاعر الكبير صلاح عبد الصبور له كتاب بهذا العنوان؛ يبدو للوهلة الأولى جامعًا لمقالات متفرقة وموضوعات شتى، لكن القارئ الفاحص المدقق، المستبصر بتجربة شاعر العربية الكبير في القرن العشرين، يدرك تمامًا أنه كان خطابًا تأمليًا هادئًا لما مر به خلال هذه العقود التي انصرمت؛ تبدو نقطة الخمسين هذه محملة بقدر ما من حصيلة (تتفاوت من واحد لآخر) معرفية وإنسانية وذوقية وروحية.. تتراكم، وتتداخل، وتتمازج، وقد تصطرع وتصطخب فيما بينها، لتنتج في النهاية هذا الكائن الذي يشارف الخمسين!
ربما تستدعي رحلة التأمل هذه الوقوف عند محطات في الذاكرة تعود إلى أبعد لحظة في تاريخ صاحبها وعَى فيها وجوده في هذا العالم، وبدأت حواسه في التنبه والالتفات لما يدور حولها! وربما يكون الاستدعاء أو التداعي متصلًا بلحظة اكتشاف خبرةٍ ما، قراءة ما، كتابٍ ما، صورة ما، وربما حادثة ما! وعبر السنوات ستتشكل أيضًا طريقة ما في اكتشاف الشخصيات وقراءتها والتعلم منها أو تجنبها بالكلية!
ولهذا آثرتُ أن أسمي هذه السلسلة أو أضع هذه الحلقات تحت لافتة عريضة عنوانها «أصداف ولآلئ ـ جولات في جنبات الذاكرة والمعرفة والتراث»، ولا أريد أن أجهدك عزيزي القارئ في تحليلٍ عميق ومفصل لرمزية الصدفة واللؤلؤة؛ هكذا هي الحياة فيما أتصور، كثير من الأصداف وقليل من الآلئ!
وإن كانت خبرة الحياة ومشوار العمر -في هذه العقود الخمسة المنصرمة أو التي تكاد تنصرم- قد جعلني أميل إلى تعديل هذه المقولة قليلًا إلى «محيطٍ من الأصداف وكثيرٍ من الآلئ»، لكن شريطة أن يقوم البحار والغواص والمنقب بالبحث داخل هذه الأصداف التي تحيط بنا من كل جانب، والكشف عما بداخلها والتأكد من عدم احتوائها على لؤلؤة أو أكثر أو العكس!
أتصور أن حياتي بأكملها قد انطوت على هذا الفعل المستمر والمتصل من الإبحار والتجوال والغوص والارتحال.. من المسح الأفقي والاستقصاء الرأسي.. من النهم المعرفي والاستسلام لغواية البحث عن المجهول، والسير في طريق طرح الأسئلة ومحاولات البحث عن أجوبة أو إجابات محتملة! فلا أحد يملك الحقيقة كاملة ولا أحد يزعم أنه وجد الخلاص إلا من رحم ربي!
محطات في الذاكرة
عمومًا لا أريد لهذه التقدمة أن تطول؛ فقط أردت أن أستميح قارئي عذرًا، وقارئ هذه الأوراق في العموم، في أن أترك نفسي على سجيتها في هذه الرحلة من الإبحار والتجوال والتنقيب والاستدعاء، في هذه الرحلة التأملية الاستقرائية (وقد تكون استقصائية.. الله أعلم!)
وفي الوقوف عند محطات في الذاكرة وفي الحياة، أتحرك بينها جيئة وذهابًا بحرية تامة بين الماضي والحاضر، تتصل برحلتي وخبرتي وسنواتي التي مضت مع الكتاب (والكتب والمكتبة) والتراث (الرسمي منه والشعبي، المدون والشفاهي، الأدبي منه وغير الأدبي) ومع قضايا الحداثة والبحث عنها ومساراتها الملتفة والملتبسة والمتعرجة، والنهضة الموءودة دائمًا والتاريخ وسردياته المتصارع عليها، والسيرة الذاتية والترجمة الشخصية والولع بالقراءة.. وكل ما من شأنه أن يمثل في التحليل الأخير أو المحصلة النهائية أصداف ولآلئ ذلك الكائن الذي يحمل اسمي.
وذلك في الغالب ولطبيعة حياة صاحبها وسيرته التي جعلته مشتغلًا بما تمناه طوال عمره، أقصد بالقراءة والكتابة، وبالتالي فستكون القراءة -فعلًا وممارسة- أحد محاور ارتكاز هذه المقالات، كما ستكون الكتابة التي شكلت مهنة صاحب هذه السطور خبرة أخرى، ووسيلة تمكن من خلالها اختبار أفكار وتصورات عدل فيها وأضاف إليها وحذف منها خلال هذه الرحلة، وأظنه سيظل في ممارسة هذا الفعل حتى آخر عمره؛ فعل المراجعة والفحص وطرح الأسئلة ومعاودة القراءة وإنتاج التفسيرات والتأويلات فيما يدور حوله وفيما يمارس من نشاط وفيما يقرأ من كتب ويناقش من نصوص ويحاضر في ندوات.. داعيًا وراجيًا أن يكون فيها ما يستحق البقاء.. وأن تكون الرحلة ملأى بالآلئ وليست محض أصداف فارغة!
خريف الغضب
لا أظن أنني أذكر شيئًا على الإطلاق عن سنواتي الأربع الأولى، لا شيء على الإطلاق، لا غمام ولا ضباب ولا نثارات ولا أي شيء! استعضتُ عن هذا بالقراءة النهمة المفصلة عن تلك السنوات الأربع؛ منذ أعلن السادات في خطابه الشهير عن استعداده للذهاب إلى آخر مكان في العالم، بل إلى الكنيست ذاته! وصولًا إلى اللحظة التي صاح فيها صيحته الأخيرة «مش معقول» ليصمت بعدها أبدًا!
أربع سنواتٍ غلَت فيها البلاد وغضب العباد، وأصبحت الدنيا على حافة البركان؛ ويلخصها الجورنالجي الأشهر في تاريخ الصحافة المصرية والعربية محمد حسنين هيكل بكلمتين صارتا عنوانًا لواحدٍ من أشهر كتبه وأكثرها مبيعََا وطباعة ربما حتى اللحظة «خريف الغضب»!
وسيكون هذا الكتاب أول ما أقرأ للكاتب السياسي الأشهر والصحفي المصري والعربي الذي تربع على عرش الصحافة والسياسية والمجال العام لأكثر من خمسين سنة، كما سيكون مقدرًا لي بعد ذلك أن أمتهن المهنة ذاتها الصحافة والكتابة.
ولم يمر سوى عامين فقط على مجيئي إلى هذه الدنيا حتى جرَت المقادير بحادث غريب وعجيب في أقصى شرق العالم العربي لتتغير الدنيا بعدها، ويكون لهذا الحادث من الآثار والتداعيات ما زال حتى اللحظة يلقي بظلاله تلك علينا هنا في مصر!
إنها الثورة الإيرانية التي تحولت بفعل فاعل (كما العادة!) إلى الثورة الإسلامية الشيعية، وبروز زعامة الخميني وإعلان ولاية الفقيه، وهروب الشاه واستقراره في مصر.. وسيكون الكتاب الأهم بالنسبة لي بعد سنوات الذي أتعرف منه على أحداث مع جرى، وجذوره، وآثاره، وأصدائه هو كتاب محمد حسنين هيكل أيضًا المعنون «مدافع آية الله ـ قصة إيران والثورة»، وهو عندي من أفضل ما قرأت باللغة العربية عن هذا الحدث الكبير.
الفترة من 77 إلى 81 عرفتُ تفاصيلها ووقائعها وأحداثها من كتب التاريخ والمذكرات والسير الذاتية ومن الأرشيف الحي، الصحافة ودوريات ذلك الزمان ومقالات الكتّاب، لم أكن وعيت أي شيء وذاكرتي مغمضة العينين سارحة في الملكوت لا تعي شيئًا، وإن كانت ربما تخزِّن أشياء. فمتى كانت اللحظة التي تقف عندها الذاكرة واعية بأن ثمة نقطة في مسار الزمن قد بدأت تتشكل ملامحها صوتًا وصورة ومفردات وعلامات، ويبدأ منها الوعي بأن هناك مشاهد ورسومًا تتحرك على صفحة الذاكرة، وتنتقل من نقطة إلى أخرى، ومن محطة إلى تاليها؟!
عشت لأروي!
يوم الاحتفال بالنصر، السادس من أكتوبر عام 1981، وضعتني أمي على كنبة الجلوس في الصالة الصغيرة جدًا لشقة جدتي لأمي، جدتي وأمي وخالاتي يعملون بهمة ونشاط ويمارسون مهام التنظيف بحماسة منقطعة النظير، يجلون الأرض ويمسحون البلاط ويرفعون أغطية الكنب البلدي لينظفوا تحتها وفي الخلفية صوت الغسالة الإيديال الجديدة ذات الخرطوم التي تهدر هدير شلالات نياجرا!
صوت مزعج لكنه يمثل الآن نوستالجيا منقطعة النظير لمن أدمنوا صوت محركات الغسالات، وما تفعله من أثر السحر والمخدر وتذهب بمدمنها إلى سلطنة النوم بلا منازع!
أذكر جيدًا أنني أجلس بجرمي الصغير متربعًا على الكنبة، أمامي التليفزيون الأبيض والأسود، وهناك احتفالات تجري.. ثم فجأة! ينقطع الإرسال ويصدر الوشيش المصاحب لانتهاء البث أو انقطاعه، وأذكر جيدًا أن ثمة حالة من الترقب والتوتر والانزعاج الشديد بدَت على وجوه جدتي وخالاتي وأمي، لم أكن أعي ما يحدث، لكني أدركت أن هناك أمرًا جللًا حدث أو أن شيئًا ما سيحدث!
لو سألتني عن أي شيء قبل هذه اللحظة فلن أجيبك أبدًا! فلا صوت ولا صورة ولا كلمة ولا أي شيء، أما لو سألتني فيما تلا هذه اللحظة من ظهيرة يوم السادس من أكتوبر عام 1981، فسيكون هناك الكثير لأتذكره وأرويه (مع الامتنان لماركيز صاحب هذه الصيحة الإنسانية المدوية.. عشت لأروي!)
ومنذ هذه اللحظة ستتداعى المشاهد والمواقف والحكايات، بعضها يأتيني عفو الخاطر ودون أدنى مجهود، وبعضها يتوارى قليلًا ولا يفصح عن مكنونه ومحتواه وتفصيله إلا بعد أن أزيح الستار عن لحظة أخرى أو حدث آخر أو موقف لا أنساه ولا ينساه أبناء جيلي..































































































































































